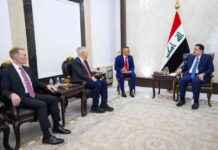تبدو شجرة عائلتي وكأنها مشروع DIY فاشل.
تم تقسيم بعض فروعه ، وضربها صاعقة ، والبعض الآخر تم ترقيعه بالوسائل المتاحة ، متماسكًا بالخوف. مع تقدمه في العمر ، تلاعبت بنهايات جديدة له ، وأنا غير مرتاح لفكرة أن أجده أصلعًا جدًا. الأطراف الاصطناعية في شكل صداقة وعلاقات خارج الأسرة لتخفيف حاجتي إلى الوحدة.
غالبًا ما تم نقش جذعها الجنف بوقاحة حب المراهقين. غير محتشم ، يرتدي ندوبه بفخر ، كتذكير بقدرته على أن يكون محبوبًا ، ويعرض نفسه بالكامل ليكون محفورًا بوعود الأبدية. إنه يفعل ذلك لنا بشكل مشترك ، أنا وهو. نحن نزدهر عندما نشعر بالاختيار ونزدهر تحت كل الأيدي التي يبدو أنها تعرف كيف تعتني.
يقول الدكتور كليمنت أن هذا لا يجعلني بالضرورة في حالة سكر. أخبرتني بصبر أنه أمر طبيعي ، وهذا ما يحدث عندما يشعر أحد والديك بأنه غير مشروط أكثر بقليل مما كان متوقعًا.
في ذلك اليوم ، بينما كنت أحاول تجنب أعين المرضى الآخرين في غرفة الانتظار بمكتبه ، صدمتني الفلاش باك. لقد كنت هنا من قبل. (أي وقت آخر غير كل يوم أربعاء بعد ظهر العام الماضي ، أعني. لأنني فهمت ذلك ؛ فكرة المتابعة ليست سيئة ، مفهوم العلاج النفسي!)
لأول مرة منذ سنوات ، فكرت في ذلك السبت الرمادي عندما وطأت قدمي لأول مرة على تلك الأرضية المغطاة بالسجاد. كان ذلك قبل بلوغ الأغلبية بقليل. لقد جئت لمقابلة طبيب آخر. زميل متقشف سأراه أخيرًا هذه المرة فقط. (المعالج مثل العاشق ؛ في بعض الأحيان عليك أن تتسوق للعثور على الحذاء المناسب!)
تذكرت ما أتى بي إلى هنا في الأصل. من الواضح أن فترة الغموض الخاصة بالمراهقة لها علاقة كبيرة بها ، لكنني فكرت بشكل أساسي في هذه اليد الممدودة في الضباب. نفس اليد التي قادتني إلى العيادة. الذي كنت أحمله بالفعل عندما كان حجمي كبيرًا بما يكفي للالتفاف حول أحد أصابعه.
بقدر ما أتذكر ، كان لدى فاني دائمًا قبضة حديدية في قفاز يغطي مانيكير فرنسي لا تشوبه شائبة. موثوقة وفعالة ، لفتت صرامتها بعناية في مظهر أثيري تقريبًا. بشعرها الأشقر الذي لا نهاية له ، وعينيها الزرقاوان اللذان يران ما يفتقده الآخرون ، وساقيها التي ما زلت أشك في اندماجها في كعوبها العالية ، بدا لي دائمًا أن فاني كانت تدور حول الملاك الحارس على ركائز. حتى 12 مرة تحركت أنا وأمي. حتى تحت أضواء النيون في المستشفى حيث تنتقل أحيانًا بين نوبات العمل ، فقط لإسعاد المرضى الذين بدأت عيونهم تنفد من البطارية. حتى عندما كانت بالكاد في العشرينات من عمرها وقضت أيامها في مسح قيعان الأطفال.
يجب أن تعلم ، لفهم المدى الكامل لتضحيتها بنفسها ، أن فاني قد افتتحت بالفعل مركزًا للرعاية النهارية في ليلة واحدة. في إحدى الأمسيات عندما لم تعد قادرة على العمل مع السيدة غايتان الرهيبة التي كانت لديها عادة مزعجة تتمثل في السماح للأطفال بالبرودة في سراويلهم المليئة بالبول ، دبرت فاني نوعًا من التمرد. عندما جاءوا لاصطحاب طفلهم ، التقت بالوالدين واحدًا تلو الآخر في ساحة انتظار السيارات للإبلاغ عن الموقف ومشاركة خطتها. في اليوم التالي ، تولت دور الحضانة بالترحيب بنا في غرفة المعيشة الصغيرة في شقتها.
منذ تلك اللحظة فصاعدًا ، لم تترك فاني حياتي أبدًا. ممطر أو مشمس ، يمكنني الاعتماد على وجوده لمواجهة أي طوفان. (على الرغم من أن تدريبي على استخدام الحمام كلفني أريكة!) فقد اصطحبتني من المدرسة عندما كنت مريضًا ، وغطت ظهري عندما أواجه مشكلة ، ولم تفوتني أبدًا أي فرصة للاحتفال بي. لرؤيتها متورطة للغاية ، كان يمكن للمرء أن يعتقد أنها قادرة على سد بطن طفل ضعيف مع كل من تصفيقها.
لكن من هي بالضبط التي تقارن بك؟ سألت أصدقائي. العمة ، العرابة ، جليسة الأطفال؟
هي التي تقسم نفسها إلى ألف لمنع الآخرين من الانهيار. فاني ، في نظري ، تجسد المظهر المادي لكل القيمة التي يمكن أن تتمتع بها الأسرة المختارة.
هناك هؤلاء البشر الذين يوزعون في طريقهم طرودًا غير مشروطة. الأشخاص الذين لا ندين لهم بشيء نظريًا وليس لديهم أي ضمان باستثمار أنفسهم معنا ، باستثناء ربما الأمل في جني القليل مما زرعوه هنا وهناك. ليس الوالدين ، الجيران المهتمين ، ميسري ورشة العمل. الكثير من البالغين المهمين في تعريف من نحن ومن نهمل أحيانًا أن نلاحظه.
لم أرَ فاني منذ عام الآن. ربما سنتان ، لا أعرف. لأن … ببساطة الحياة. ومع ذلك ، لأنها عرفت كيف تسمعني وتراني عندما كان الأمر أكثر أهمية ، لأنها عرفت كيف تتصرف حيث انسحب الآخرون ، ستنتمي فاني دائمًا إلى فئة أولئك الذين بقوا.
أنهيت ملاحظتي عندما بدأت ؛ أقول لنفسي أنني يجب أن أكتب إلى فاني لأشكرها …